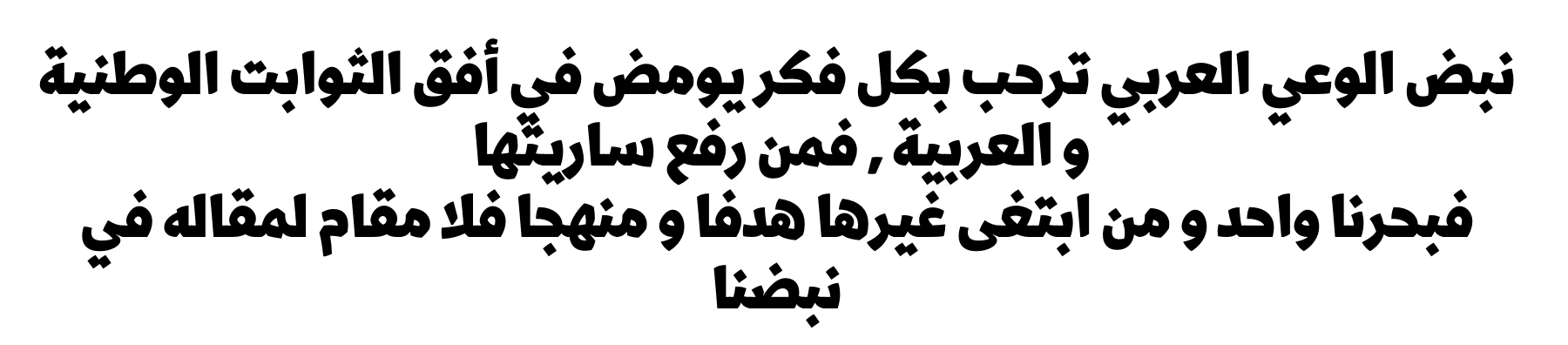المخزن دولة فاشلة آيلة للإنهيار

حالة شغور فعلية

ماء العينين لكحل
يعيش النظام المخزني في المغرب خلال العقد الأخير، وخصوصا السنوات القليلة الماضية، مرحلة جديدة من عمره الذي يمتد منذ عصر الأسرة السعدية في المغرب، حيث بلغ حدود الشيخوخة الأخيرة، ودخل مرحلة لفظ أنفاسه الأخيرة، بالرغم من تمسكه بالبقاء بكل ما أوتي من حيلة، ودهاء، ومكر وأدوات.
ومن أهم إشارات قرب نهاية نظام المخزن، الهوة السحيقة التي تفصله حاليا عن الشعب المغربي بمختلف طبقاته، بما في ذلك الطبقة الوسطى، بل وحتى الغالبية العظمى من النخب الاقتصادية والثقافية والسياسية في المغرب، تعيش مرحلة ضياع حقيقي حيث لا تجد فرصا حقيقية للفعل في حاضر ،ومستقبل البلاد إلا على هوامش الريع أو التبعية التي يفرضها نظام المخزن على كل من يريد أن يشارك في “لعبته” التي يتحكم فيها منذ قرون، بالسيطرة على مقدرات وثروات ومصير الشعب المغربي وعلى الحياة السياسية، والاقتصادية في المغرب.
من يحكم المغرب؟
سؤال قد يبدو غريبا للبعض، لكنه في حقيقة الأمر سؤال وجيه جدا إذا ما فهم القارئ طبيعة الحكم والنظام في المغرب. فالحياة السياسة في هذا البلد صعبة الفهم على من لم يعش فيه ليفهم طبيعة وآليات ممارسة السلطة الحقيقية في البلد.
وقد يستغرب البعض من قولنا إن المغرب هو ربما البلد الوحيد الذي لا تحكمه الحكومة الرسمية التي تقدم للعالم على أنها الحكومة المغربية، حيث أن جميع أعضائها، من الوزير الأول إلى أدنى وزير فيها، هم مجرد “مدراء” لبعض القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ربما، وغيرها من القطاعات الخدمية، في حين أن السلطة الحقيقية التي تحكم البلد، تتركز جميعها في يد من يحكم القصر، ونعني هنا بالسلطة الحقيقية السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، تنضاف إليها السيطرة التامة على الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية والخارجية والعدل، وبالتالي فوظيفة هؤلاء الوزراء وغيرهم من السياسيين الذين يشتغلون في وظائف خدماتية، هو لعب دور مخفف الصدمات عن القصر، بحيث يمكن لسيده عند اشتدادا أزمة ما أن يحل الحكومة، أو يقيل وزيرا أو “يعاقب” مسؤولا، ويلعب دور الحكم العادل الذي يضمن التوازن في البلد. في حين أن الحقيقة هي أن الملك، وحاشيته الحاكمة الفعلية باسمه (أي القصر) هم المسؤولون الحقيقيون عن تدهور الأوضاع في المغرب، وعن الخيارات السياسية الخطيرة التي تبناها هذا النظام منذ سقوطه في أحضان فرنسا، ليلعب دور بيدقها في المنطقة، ويتبنى سياسة توسعية، استعمارية، جعلته عدوا حقيقيا لجميع شعوب دول الجوار (اسبانيا، الجزائر، الصحراء الغربية، موريتانيا، وغيرها من الشعوب الأفريقية الخاضعة للسيطرة الفرنسية عبر حكام تصنعهم باريس).
وطبعا، اختلفت طبيعة ومدى سيطرة القصر الملكي على هذه السلط، باختلاف الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في المغرب منذ بداية
عهد الحماية، حيث ينبغي لمن يريد فهم طبيعة النظام الملكي الحالي أن يفهم أيضا أن الملكية في المغرب تختلف في شكلها الحالي عن الملكية في فترة ما قبل الحماية (أي 1912).
وجميع المغاربة يعلمون الآن أن الأسرة الحاكمة في الرباط كانت فيما مضى مجرد سلطنة تقليدية لا تحكم في واقع الحال إلا ما كان يعرف قديما باسم بلاد المخزن، أي مثلث الرباط، فاس مراكش في حين اختلفت قدرات ملوك المغرب على فرض احترام سيطرتهم على ما كان يعرف باسم “بلاد السيبة” وهي المناطق الجبلية (الريف، جبال الأطلس) التي يصعب على جيوش السلطان الوصول إليها، وكل المنطقة الواقعة في حدود واد نون وامتدادته الشرقية.
بل حتى الحواضر الرئيسية التي كانت “نظريا” تحت سلطة السلطان، كمراكش على سبيل المثال، كانت في واقع الأمر تحت السيطرة الفعلية لعائلة الباشا التهامي لكلاوي في مرحلة الحماية ولم يكن سلاطين المغرب يحكمونها إلا رمزيا، ومثلها مثلا منطقة واد نون، التي كانت تحت حكم عائلة أهل بيروك، ولولا تدخل الدولة الفرنسية التي بسطت سيطرتها العسكرية والإدارية على مختلف مناطق المغرب في حدوده الدولية المعاصرة، لكانت الأسرة العلوية قد تلاشت ربما في عشرينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي لعجزها عن فرض نفوذها على جل الباشوات والقياد الذين كان معظمهم يمارس السلطان الحقيقي على مناطق نفوذهم المختلفة (يمكن القول أن الحسن الثاني كان أول ملك فعلي للمغرب في حدوده المعاصرة).
المرحلة الحالية، مرحلة ضعف الملكية في المغرب
معلوم أن جميع الملكيات عبر التاريخ كانت تعرف مراحل قوة، ومراحل ضعف تتوقف أساسا على طبيعة النظام الحاكم، ومدى قوة وسيطرة الملك شخصيا، بالإضافة طبعا إلى إحسانه فرض هيبته على عماله ومعاونيه لتنفيذ إرادته في تسيير الشأن العام.
ويمكن القول أن الحسن الثاني خلال مرحلة حكمه التي دامت 38 سنة (زائد السنوات الأربع التي مارس فيها نوعا من السلطة من وراء ظهر والده وهو ولي للعهد)، قد تمكن من تأسيس أسس النظام الملكي الشمولي في المغرب، ومارس الحكم الفعلي للبلاد متخلصا خلال هذه الفترة من كل منافسيه في الشعبية والشرعية (قيادات المقاومة، والقيادات السياسية المغربية التي كانت تتمتع أحيانا بشرعية شعبية أكثر من الملك، مثل المهدي بن بركة، ولفقيه البصري، وغيرهم كثيرون، ناهيك عن تخلصه من جميع القوى السياسية الفعلية في المغرب خاصة اليسار خلال مرحلة الستينات والسبعينات).
لكن، بمجرد وفاة الحسن الثانية سنة 1999، دخل المغرب مرحلة جديدة، امتازت في بداياتها بانتعاش آمال الشعب المغربي في إمكانية إصلاح النظام للخروج من الأزمات الكثيرة التي خلفها عهد الملك الراحل، الذي عرف اختصارا بسنوات الجمر والرصاص للعنف الشديد الذي طبعه، لتبدأ مرحلة “ملك الفقراء”، والملك الشاب الوديع الذي يريد التخلص من الفساد والمفسدين، ليكتشف الشعب المغربي بعد سنوات قليلة أن كل هذه الشعارات ما هي إلا أكاذيب غير قابلة للتطبيق، لأن “ملك الفقراء” هو في الحقيقة المالك الأول، والمستثمر الأول، ورجل الأعمال الأول، والمغتصب الأول لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، وهو في نفس الوقت من وجد في نفسه من القدرة على خداع الشعب المغربي المقهور عبر سؤاله الشهير في إحدى خطبه النادرة، حين طرح السؤال المستفز: “أين الثروة؟”.
حالة شغور فعلية
ما ميز مرحلة الملك الحالي في المغرب هو الغياب الحقيقي لأي قيادة سياسية ذات كاريزما يمكنها أن تقنع المغاربة بمشروع ما، مهما كان نوعه، وقد كان ذلك نتيجة حتمية لعقود من القمع والتقتيل والتشريد لجميع القيادات والتيارات السياسية الحقيقية التي أبيدت عن بكرة أبيها، لتعوض ببيادق حزبية من مختلف الألوان السياسية، التي لا تتمتع لا بالشعبية الضرورية لأي حزب، ولا حتى بالقدرة على تقديم الطرح والاقتراح السياسي الضروري لتحريك أي مجتمع. بل هي جميعها، دون استثناء، أحزاب انتخابية، مجالها الحصري يتمثل في المشاركة في الانتخابات الصورية على أمل الحصول على مناصب ومكتسبات في تسيير الخدمات التي يجود بها عليهم المالك الفعلي للبلاد.
وبالتالي، تدهور الوضع العام في المغرب بشكل طبيعي، بسبب استشراء الفساد، الذي يضرب الآن في جميع مفاصل البلاد، وفي جميع مؤسساتها، ومصالحها، حيث بات جزء لا يتجزأ من المنظومة العامة في المغرب.
وبطبيعة الحال، لا نحتاج للدخول في تفاصيل هذا التدهور الذي نشير إليه، فيكفي القارئ الكريم البحث البسيط للخروج بأرقام تكشف حقيقة هذه المملكة الاقتصادية، والتعليمية، والسياسية، والاجتماعية وغيرها، حيث تتذيل المملكة جميع رتب تصنيفات الدول التي يمكن تخيلها، في حين تصل مديونيتها حاليا أزيد من 90 في المائة من الناتج المحلي، مع استمرار الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية خطيرة (اعتماد متزايد على المديونية لسد الحاجيات الأساسية) لن تقود البلاد إلا إلى مزيد من الأزمات مستقبلا.
وما زاد الطين بلة هو ضعف شخصية الملك محمد السادس، واعتلال صحته، وعدم رغبته على ما يبدو في الحكم، وهو ما يفسر سفرياته الكثيرة، وغيابه شبه الدائم عن متابعة الشأن العام، تاركا البلاد في أيدي مجموعة صغيرة من “خدامه” الذين لم يكونوا مستعدين للحكم، ولا يملكون التجربة الضرورية لذلك، وبالتالي راكموا آلاف الأخطاء خلال ممارستهم الفعلية للسلطة باسم الملك، مركزين بالأساس على خدمة الأسرة المالكة وتنمية سيطرتها المالية والاقتصادية في البلد، وطبعا، ملء جيوبهم بالمال العام المنهوب.
المستقبل المنظور
يبدو أن الملكية في المغرب تحتضر، فلقد أثبتت عجزا مركبا عن إدارة هذا البلد الاستراتيجي في شمال أفريقيا، وتخلفت عن انتهاز جميع الفرص السياسية والاقتصادية التي كانت بين أيديها منذ السبعينات. كما أن الخيارات السياسية التي تبنتها أثبتت مخالفتها للتاريخ، فبدلا من اتباع سياسة وطنية تهدف لتحقيق الاستقلال الفعلي عن التبعية لفرنسا، وبناء اقتصاد وطني يخدم الشعب المغربي وجيرانه وقارته، اتبع الملك الحسن الثاني سياسة تبعية مطلقة للغرب، خاصة فرنسا، ورهن مستقبل بلاده للبنك الدولي، ولمجموعة من الدول الغربية، التي تملي عليه كيفية تسيير البلاد، وتستطيع بمجرد سحب استثماراتها أن تزج بالمغرب في مصاف الدول المفلسة.
كما أن النظام المخزني، ولضمان حماية ودعم الغرب، وافق على لعب دور خنجر الغدر في الخاصرة الشمالية للقارة، لحرمان شعوبها من الاستقلال، ومن التحرر والتكامل، فحاول في البداية زعزعة استقرار الجزائر بداية الستينات، ثم وجه أنظاره إلى الصحراء الغربية وموريتانيا خلال الستينات والسبعينات، وظل يدور في محور الغرب طيلة الثمانينات وحتى الآن، مغردا خارج سرب التحرر الأفريقي، خادما مطيعا للسياسات الفرنسية في المنطقة وفي أفريقيا على العموم.
لكل هذا، ولغيره من العناصر المختلفة التي شابت مسيرة النظام المخزني في المغرب، يتوقع الكثيرون نهاية الملكية في المغرب في المنظور القريب، حيث فقدت جملة أسباب بقائها، كما أنها عجزت خلال العقود الأخيرة عن إنتاج نخب حقيقية قادرة على حمايتها والحفاظ على تقاليدها، وباتت تعتبر لدى غالبية الشعب المغربي العدو الحقيقي للحرية، والاستقلال، والرخاء في المغرب.
فهل يكون الحسن الثالث آخر ملوك المغرب؟ وهل ينجح الشعب المغربي في إنتاج نخب سياسية حقيقية قادرة على انتشاله من الخراب؟ وهل تحسن النخب المغربية اختيار توجهاتها السياسية، وتغيير علاقاتها مع جميع جيرانها للخروج من الأزمة؟ أم هل سنشهد في السنوات القليلة القادمة تمزقا، وتشرذما وانهيارا شبه تام للمملكة المغربي، التي أصبحت بحق “الرجل المريض” في شمال أفريقيا، المقبل على التفتت كدولة فاشلة؟ أسئلة كثيرة يمكن طرحها هنا.
لكن، وحدهم المغاربة يستطيعون تقديم الاجابات مستقبلا ويملكون الحق في ذلك.
عيش النظام المخزني في المغرب خلال العقد الأخير، وخصوصا السنوات القليلة الماضية، مرحلة جديدة من عمره الذي يمتد منذ عصر الأسرة السعدية في المغرب، حيث بلغ حدود الشيخوخة الأخيرة، ودخل مرحلة لفظ أنفاسه الأخيرة، بالرغم من تمسكه بالبقاء بكل ما أوتي من حيلة، ودهاء، ومكر وأدوات.
ومن أهم إشارات قرب نهاية نظام المخزن، الهوة السحيقة التي تفصله حاليا عن الشعب المغربي بمختلف طبقاته، بما في ذلك الطبقة الوسطى، بل وحتى الغالبية العظمى من النخب الاقتصادية والثقافية والسياسية في المغرب، تعيش مرحلة ضياع حقيقي حيث لا تجد فرصا حقيقية للفعل في حاضر ،ومستقبل البلاد إلا على هوامش الريع أو التبعية التي يفرضها نظام المخزن على كل من يريد أن يشارك في “لعبته” التي يتحكم فيها منذ قرون، بالسيطرة على مقدرات وثروات ومصير الشعب المغربي وعلى الحياة السياسية، والاقتصادية في المغرب.
من يحكم المغرب؟
سؤال قد يبدو غريبا للبعض، لكنه في حقيقة الأمر سؤال وجيه جدا إذا ما فهم القارئ طبيعة الحكم والنظام في المغرب. فالحياة السياسة في هذا البلد صعبة الفهم على من لم يعش فيه ليفهم طبيعة وآليات ممارسة السلطة الحقيقية في البلد.
وقد يستغرب البعض من قولنا إن المغرب هو ربما البلد الوحيد الذي لا تحكمه الحكومة الرسمية التي تقدم للعالم على أنها الحكومة المغربية، حيث أن جميع أعضائها، من الوزير الأول إلى أدنى وزير فيها، هم مجرد “مدراء” لبعض القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ربما، وغيرها من القطاعات الخدمية، في حين أن السلطة الحقيقية التي تحكم البلد، تتركز جميعها في يد من يحكم القصر، ونعني هنا بالسلطة الحقيقية السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، تنضاف إليها السيطرة التامة على الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية والخارجية والعدل، وبالتالي فوظيفة هؤلاء الوزراء وغيرهم من السياسيين الذين يشتغلون في وظائف خدماتية، هو لعب دور مخفف الصدمات عن القصر، بحيث يمكن لسيده عند اشتدادا أزمة ما أن يحل الحكومة، أو يقيل وزيرا أو “يعاقب” مسؤولا، ويلعب دور الحكم العادل الذي يضمن التوازن في البلد. في حين أن الحقيقة هي أن الملك، وحاشيته الحاكمة الفعلية باسمه (أي القصر) هم المسؤولون الحقيقيون عن تدهور الأوضاع في المغرب، وعن الخيارات السياسية الخطيرة التي تبناها هذا النظام منذ سقوطه في أحضان فرنسا، ليلعب دور بيدقها في المنطقة، ويتبنى سياسة توسعية، استعمارية، جعلته عدوا حقيقيا لجميع شعوب دول الجوار (اسبانيا، الجزائر، الصحراء الغربية، موريتانيا، وغيرها من الشعوب الأفريقية الخاضعة للسيطرة الفرنسية عبر حكام تصنعهم باريس).
وطبعا، اختلفت طبيعة ومدى سيطرة القصر الملكي على هذه السلط، باختلاف الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في المغرب منذ بداية
عهد الحماية، حيث ينبغي لمن يريد فهم طبيعة النظام الملكي الحالي أن يفهم أيضا أن الملكية في المغرب تختلف في شكلها الحالي عن الملكية في فترة ما قبل الحماية (أي 1912).
وجميع المغاربة يعلمون الآن أن الأسرة الحاكمة في الرباط كانت فيما مضى مجرد سلطنة تقليدية لا تحكم في واقع الحال إلا ما كان يعرف قديما باسم بلاد المخزن، أي مثلث الرباط، فاس مراكش في حين اختلفت قدرات ملوك المغرب على فرض احترام سيطرتهم على ما كان يعرف باسم “بلاد السيبة” وهي المناطق الجبلية (الريف، جبال الأطلس) التي يصعب على جيوش السلطان الوصول إليها، وكل المنطقة الواقعة في حدود واد نون وامتدادته الشرقية.
بل حتى الحواضر الرئيسية التي كانت “نظريا” تحت سلطة السلطان، كمراكش على سبيل المثال، كانت في واقع الأمر تحت السيطرة الفعلية لعائلة الباشا التهامي لكلاوي في مرحلة الحماية ولم يكن سلاطين المغرب يحكمونها إلا رمزيا، ومثلها مثلا منطقة واد نون، التي كانت تحت حكم عائلة أهل بيروك، ولولا تدخل الدولة الفرنسية التي بسطت سيطرتها العسكرية والإدارية على مختلف مناطق المغرب في حدوده الدولية المعاصرة، لكانت الأسرة العلوية قد تلاشت ربما في عشرينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي لعجزها عن فرض نفوذها على جل الباشوات والقياد الذين كان معظمهم يمارس السلطان الحقيقي على مناطق نفوذهم المختلفة (يمكن القول أن الحسن الثاني كان أول ملك فعلي للمغرب في حدوده المعاصرة).
المرحلة الحالية، مرحلة ضعف الملكية في المغرب
معلوم أن جميع الملكيات عبر التاريخ كانت تعرف مراحل قوة، ومراحل ضعف تتوقف أساسا على طبيعة النظام الحاكم، ومدى قوة وسيطرة الملك شخصيا، بالإضافة طبعا إلى إحسانه فرض هيبته على عماله ومعاونيه لتنفيذ إرادته في تسيير الشأن العام.
ويمكن القول أن الحسن الثاني خلال مرحلة حكمه التي دامت 38 سنة (زائد السنوات الأربع التي مارس فيها نوعا من السلطة من وراء ظهر والده وهو ولي للعهد)، قد تمكن من تأسيس أسس النظام الملكي الشمولي في المغرب، ومارس الحكم الفعلي للبلاد متخلصا خلال هذه الفترة من كل منافسيه في الشعبية والشرعية (قيادات المقاومة، والقيادات السياسية المغربية التي كانت تتمتع أحيانا بشرعية شعبية أكثر من الملك، مثل المهدي بن بركة، ولفقيه البصري، وغيرهم كثيرون، ناهيك عن تخلصه من جميع القوى السياسية الفعلية في المغرب خاصة اليسار خلال مرحلة الستينات والسبعينات).
لكن، بمجرد وفاة الحسن الثانية سنة 1999، دخل المغرب مرحلة جديدة، امتازت في بداياتها بانتعاش آمال الشعب المغربي في إمكانية إصلاح النظام للخروج من الأزمات الكثيرة التي خلفها عهد الملك الراحل، الذي عرف اختصارا بسنوات الجمر والرصاص للعنف الشديد الذي طبعه، لتبدأ مرحلة “ملك الفقراء”، والملك الشاب الوديع الذي يريد التخلص من الفساد والمفسدين، ليكتشف الشعب المغربي بعد سنوات قليلة أن كل هذه الشعارات ما هي إلا أكاذيب غير قابلة للتطبيق، لأن “ملك الفقراء” هو في الحقيقة المالك الأول، والمستثمر الأول، ورجل الأعمال الأول، والمغتصب الأول لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، وهو في نفس الوقت من وجد في نفسه من القدرة على خداع الشعب المغربي المقهور عبر سؤاله الشهير في إحدى خطبه النادرة، حين طرح السؤال المستفز: “أين الثروة؟”.
حالة شغور فعلية
ما ميز مرحلة الملك الحالي في المغرب هو الغياب الحقيقي لأي قيادة سياسية ذات كاريزما يمكنها أن تقنع المغاربة بمشروع ما، مهما كان نوعه، وقد كان ذلك نتيجة حتمية لعقود من القمع والتقتيل والتشريد لجميع القيادات والتيارات السياسية الحقيقية التي أبيدت عن بكرة أبيها، لتعوض ببيادق حزبية من مختلف الألوان السياسية، التي لا تتمتع لا بالشعبية الضرورية لأي حزب، ولا حتى بالقدرة على تقديم الطرح والاقتراح السياسي الضروري لتحريك أي مجتمع. بل هي جميعها، دون استثناء، أحزاب انتخابية، مجالها الحصري يتمثل في المشاركة في الانتخابات الصورية على أمل الحصول على مناصب ومكتسبات في تسيير الخدمات التي يجود بها عليهم المالك الفعلي للبلاد.
وبالتالي، تدهور الوضع العام في المغرب بشكل طبيعي، بسبب استشراء الفساد، الذي يضرب الآن في جميع مفاصل البلاد، وفي جميع مؤسساتها، ومصالحها، حيث بات جزء لا يتجزأ من المنظومة العامة في المغرب.
وبطبيعة الحال، لا نحتاج للدخول في تفاصيل هذا التدهور الذي نشير إليه، فيكفي القارئ الكريم البحث البسيط للخروج بأرقام تكشف حقيقة هذه المملكة الاقتصادية، والتعليمية، والسياسية، والاجتماعية وغيرها، حيث تتذيل المملكة جميع رتب تصنيفات الدول التي يمكن تخيلها، في حين تصل مديونيتها حاليا أزيد من 90 في المائة من الناتج المحلي، مع استمرار الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية خطيرة (اعتماد متزايد على المديونية لسد الحاجيات الأساسية) لن تقود البلاد إلا إلى مزيد من الأزمات مستقبلا.
وما زاد الطين بلة هو ضعف شخصية الملك محمد السادس، واعتلال صحته، وعدم رغبته على ما يبدو في الحكم، وهو ما يفسر سفرياته الكثيرة، وغيابه شبه الدائم عن متابعة الشأن العام، تاركا البلاد في أيدي مجموعة صغيرة من “خدامه” الذين لم يكونوا مستعدين للحكم، ولا يملكون التجربة الضرورية لذلك، وبالتالي راكموا آلاف الأخطاء خلال ممارستهم الفعلية للسلطة باسم الملك، مركزين بالأساس على خدمة الأسرة المالكة وتنمية سيطرتها المالية والاقتصادية في البلد، وطبعا، ملء جيوبهم بالمال العام المنهوب.
المستقبل المنظور
يبدو أن الملكية في المغرب تحتضر، فلقد أثبتت عجزا مركبا عن إدارة هذا البلد الاستراتيجي في شمال أفريقيا، وتخلفت عن انتهاز جميع الفرص السياسية والاقتصادية التي كانت بين أيديها منذ السبعينات. كما أن الخيارات السياسية التي تبنتها أثبتت مخالفتها للتاريخ، فبدلا من اتباع سياسة وطنية تهدف لتحقيق الاستقلال الفعلي عن التبعية لفرنسا، وبناء اقتصاد وطني يخدم الشعب المغربي وجيرانه وقارته، اتبع الملك الحسن الثاني سياسة تبعية مطلقة للغرب، خاصة فرنسا، ورهن مستقبل بلاده للبنك الدولي، ولمجموعة من الدول الغربية، التي تملي عليه كيفية تسيير البلاد، وتستطيع بمجرد سحب استثماراتها أن تزج بالمغرب في مصاف الدول المفلسة.
كما أن النظام المخزني، ولضمان حماية ودعم الغرب، وافق على لعب دور خنجر الغدر في الخاصرة الشمالية للقارة، لحرمان شعوبها من الاستقلال، ومن التحرر والتكامل، فحاول في البداية زعزعة استقرار الجزائر بداية الستينات، ثم وجه أنظاره إلى الصحراء الغربية وموريتانيا خلال الستينات والسبعينات، وظل يدور في محور الغرب طيلة الثمانينات وحتى الآن، مغردا خارج سرب التحرر الأفريقي، خادما مطيعا للسياسات الفرنسية في المنطقة وفي أفريقيا على العموم.
لكل هذا، ولغيره من العناصر المختلفة التي شابت مسيرة النظام المخزني في المغرب، يتوقع الكثيرون نهاية الملكية في المغرب في المنظور القريب، حيث فقدت جملة أسباب بقائها، كما أنها عجزت خلال العقود الأخيرة عن إنتاج نخب حقيقية قادرة على حمايتها والحفاظ على تقاليدها، وباتت تعتبر لدى غالبية الشعب المغربي العدو الحقيقي للحرية، والاستقلال، والرخاء في المغرب.
فهل يكون الحسن الثالث آخر ملوك المغرب؟ وهل ينجح الشعب المغربي في إنتاج نخب سياسية حقيقية قادرة على انتشاله من الخراب؟ وهل تحسن النخب المغربية اختيار توجهاتها السياسية، وتغيير علاقاتها مع جميع جيرانها للخروج من الأزمة؟ أم هل سنشهد في السنوات القليلة القادمة تمزقا، وتشرذما وانهيارا شبه تام للمملكة المغربي، التي أصبحت بحق “الرجل المريض” في شمال أفريقيا، المقبل على التفتت كدولة فاشلة؟ أسئلة كثيرة يمكن طرحها هنا.
لكن، وحدهم المغاربة يستطيعون تقديم الاجابات مستقبلا ويملكون الحق في ذلك.