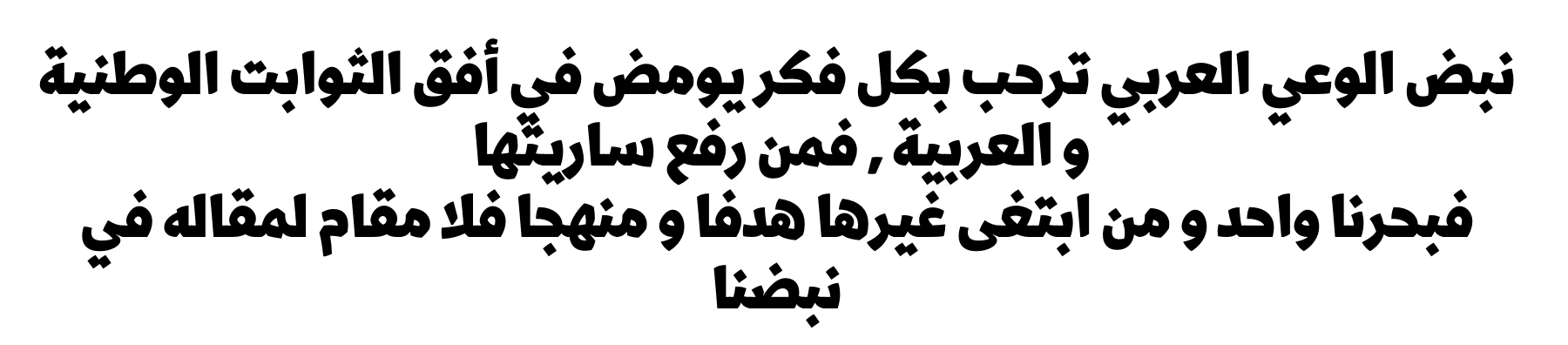الصيف ضيَّعت اللبن…الهروب من التنمية بالحماية الشعبية (حلقة 3-الأخيرة)

المشكلة في التطبيع الاقتصادي وليس فقط في الشركات العاملة في المستوطنات
د. عادل سماره
كما أشرنا في الحلقتين السابقتين فإن تبني الكيان الصهيوني للسياسة النيولبرالية وخاصة بعد أن وصول الليكود للحكم عام 1977 وتعيين سيمحا إيرلي وزيرا للمالية وتطبيق وصفات فريق اقتصاديي شيكاغو وعلى رأسهم ملتون فريدمان (المدرسة النقودية التي أسست للنيولبرالية) والذي شغل مستشارا للديكتاتور بيونشيت في تشيلي، هذه السياسات فتحت الطريق لرأس المال المعولم مجسدا في شركات متعددة الجنسيات لإقامة فروعا لها في الكيان الصهيوني.
في الفترة ما بين 1991 – 93 وخاصة بعد مؤتمر مدريد “للسلام” وجولات التفاووض العشرة التي تلته بين فلسطينيين برئاسة د. حيدر عبد الشافي وفريق من المطبعين الفلسطينيين/ات قدمت إدارة كلينتون إلى الكيان الصهيوني ضمانات قروض بمقدار 10 مليار دولار، وكانت مشروطة بأن لا يقوم الكيان بتوسيع المستوطنات في المحتل 1967.
وكان ذلك مثابة تعمية عن حقيقة توسع الاستيطان. أذكر حينها (1994) أنني تابعت الأمر حيث كنت أعمل مستشارا إقتصاديا لمشروع إدرار الدخل في الأونروا وكان هناك فريق من ثلاثين مراقب يعملون في الأونروا فلسطينيين وأجانب وكانت تقاريرهم جميعها تؤكد مواصلة توسع المستوطنات. عملت سنة واحدة حيث تم تذويب ناعم لوظيفتي لأنني رفضت المشاركة في محادثات بروتوكول باريس الاقتصادي.
وبدورها، فإن اتفاقات أوسلو كانت نعمة للاقتصاد الصهيوني حيث تم تصويرها على أنها فتحت باب “السلام” في المنطقة مما حفز الاستثمارات الأجنبية للتدفق إلى الكيان الصهيوني والتي قدرت ب 94 مليار دولار. لقد أتت هذا الاستثمارات كي تحتضن وتشغَّل النعمة الديمغرافية (قرابة مليون مستوطن جديد من الاتحاد السوفييتي إلى الكيان) التي قدمها جورباتشوف إلى الكيان الصهيوني قبل أن ينجز مهمته الأساس وهي تفكيك الاتحاد السوفييتي.
وعليه، فإن ضمانات القروض الأمريكية كانت مثابة توفير بنية تحتية تأهيلية في الكيان بما في ذلك المستوطنات لاستيعاب عمل الشركات في الكيان والمستوطنات على حد سواء.
وهنا نضع اصبعنا على بيت القصيد.
فهل يُعقل أن تعمل شركة أجنبية أو صهيونية في الأرض المحتلة 1948 دون أن تفتح لها فرعا، إن وجدت ذلك مربحا، أو حصلت على قرض تطوير ومحفزات، في المستوطنات؟
ما هي العوامل التي يمكن أن تمنع تمدد هذه الشركات من حيفا إلى المستوطنات في الأغوار أو الخليل!
ما أقصده تحديداً هو نفاق الأمم المتحدة التي تنتقد عمل شركات صهيونية أو دولية صهيونية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لأن هذا النفاق يقوم على اعتبار الكيان الصهيوني كيانا “شرعيا” وبأن خطيئته فقط في احتلال الضفة الغربية والاستيطان وتنشيط الشركات فيها.
وهذا يفتح على خطورة التطبيع الفلسطيني الذي يعترف بالكيان الصهيوني على فلسطين المحتلة 1948، بينما يعترض على الاستيطان في الضفة الغربية. وهذا التطبيع هو الذي ساهم في لجم المقاطعة العربية وخلخلة دورها المهتز اصلا مما قاد لاحقاً إلى توقف شبه تام للمقاطعة العربية للكيان الصهيوني وصولا إلى موجة التطبيع الرسمي العربي الثانية أقصد أنظمة الخليج بعد الموجة الأولى أي النظامين المصري والأردني و م.ت.ف.
بكلام موجز، لا قيمة عملية لنقد عمل شركات في المستوطنات طالما لم يتأسس الأمر على مقاطعة الكيان الصهيوني نفسه.
وفي هذا الصدد، يمكن لفت النظر إلى قرارات سلطة الحكم الذاتي بمقاطعة منتجات المستوطنات والتي كانت تشتد لغويا ثم تعود لتخبو بينما الطبيعي أن تكون مقاطعة اقتصاد الكيان نفسه إلى أعلى درجة ممكنة وهذا لم يتم الشغل عليه بشكل جاد. وكما اشرنا فقد وُجد إضافة للسلطة السياسية اقتصاديين محليين يُنظِّرون للتبعية للاقتصاد الصهيوني.
لا يمكن الاكتفاء بنقد وجود شركات في المستوطنات، وإن كانت هذه خطوة مقبولة، ولذا، فإن مبالغة سلطة الحكم الذاتي في أهمية تقرير مكتب حقوق الإنسان ليست مبررة لأنها تنطلق من الإقرار ب “مشروعية” الكيان الصهيوني نفسه!
تعمل هذه الشركات الموجودة في الضفة الغربية في خدمة الكيان الصهيوني في تغلغله في الضفة الغربية ليس فقط لمجرد وجودها الفيزيائي على الأرض. فهي تقدم خدمات للأمن الصهيوني في الضفة المحتلة، وخدمات في هدم البيوت وتوسيع الوحدات السكنية التي تُبنى على أراضي الضفة الغربية، وتقدم خدمات أمنية لمخابرات الكيان، وخدمات صيانة ونقل وخدمات استغلال المياه في الضفة الغربية وصولا حتى إلى المساهمة في تلويث المياه في الضفة الغربية.
وعليه، فهذه الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة ليست فقط مقامة على أراضي الضفة بل هي جزء من شبكة دور المستوطنات في إغراق السوق المحلي بمنتجات العدو وتخريب البيئة وخدمة الدور الأمني للكيان في هذا الجزء من فلسطين المحتلة.
هذا ما يجب أن يتم التوجه به إلى الأمم المتحدة وإلى المقاطعة العربية ليكون الموقف ضد الكيان بأجمعه وليس فقط ضد المستوطنات.
في جانب آخر، يعيدنا هذا الأمر إلى ما كتبناه قبل فترة قصيرة عن سياسات “الجسور المفتوحة” التي صاغها وزير حرب الكيان عام 1967 موشيه ديان والتي شكلت المدماك الأساسي للتطبيع اللاحق فلسطينيا وعربيا.
لعل آخر اختبار لهذه الجسور واتفاق أوسلو ووادي عربة هو ما قرره وزير “الأمن”الصهيوني نفتالي بينيت حيث قرر منع دخول المنتجات الزراعية من الضفة الغربية المحتلة إلى كل من الكيان نفسه والأردن ايضاً.
قرار وزير العدو هذا يكشف ويُحرج المطبعين سواء في السلطة الفلسطينية أو الأردن. ذلك لأن القرار النهائي في التبادل الاقتصادي بين المحتل 1967 والمحتل 1948 والأردن هو بيد الكيان الصهيوني حصرا وفقط. وهذا ما تم ويتم التغطية عليه من الفلسطينيين والأردنيين وحتى مختلف البلدان العربية التي عقدت معها سلطة الحكم الذاتي اتفاقات اقتصادية على الورق.
وقد برع مركز “ماس” في رام الله في توليد عديد الكتب والدراسات والتقارير عن الاتفاقات الاقتصادية مع هذه الدولة أو تلك دون أن يكلف اي باحث نفسه بوضع على الأقل جملة واحدة سواء في أول الكتاب او آخره تقول مثلاً: “ولكن كل هذا مرهون بموافقة إسرائيل”!
لا يدري المرء على ماذا راهن هؤلاء!
طبعاً، كان قرار نفتالي بينيت رداً على قرار سلطة الحكم الذاتي عدم استيراد العجول من الكيان الصهيوني، ولا ندري لماذا العجول فقط؟ هذا مع العلم أن بوسع المستهلك المحلي الاستغناء تماما عن اللحوم الحمراء لصالح الأقل ضرراً صحيا اي اللحوم البيضاء لا سيما وأن إنتاج اللحوم البيضاء في الضفة الغربية كثيرا ما يزيد عن حاجة السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن هذا الإنتاج متذبذب ويمكن ضبطه.
نخلص إلى القول بأن أية سياسة اقتصادية لا تقوم على التنمية بالحماية الشعبية وخاصة مقاطعة منتجات الاحتلال، وتكريس الجهد لإنتاج الحاجات الاساسية للسوق المحلية هي القاعدة الذهبية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وهي الحد الأدنى من المقاومة على الصعيد الاقتصادي على الأقل.
مواضيع متعلقة
الصيف ضيَّعت اللبن…الهروب من التنمية بالحماية الشعبية (حلقة 1)
الصيف ضيَّعت اللبن…الهروب من التنمية بالحماية الشعبية (حلقة 2)