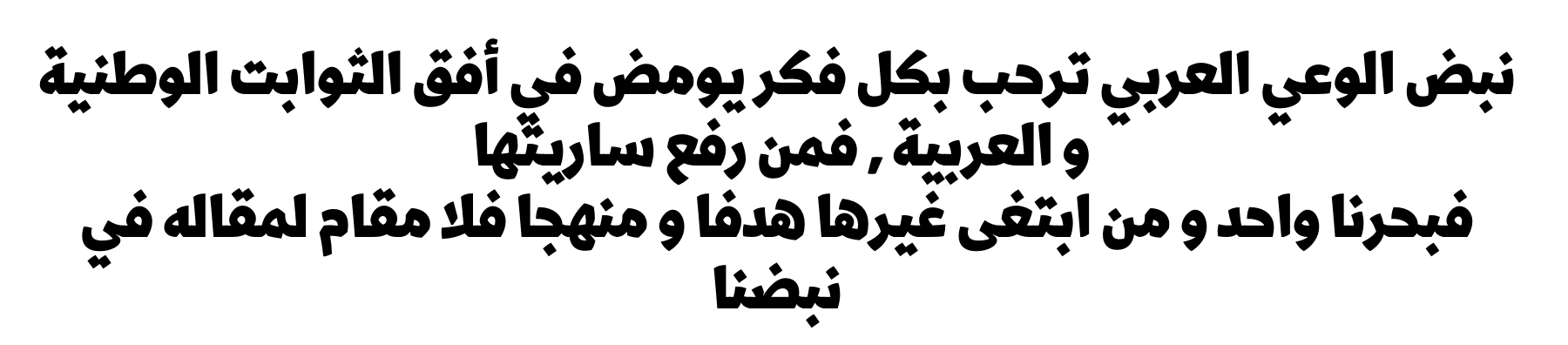تراثنا … وكيف نقرأه في زمن الهزيمة: مراجعة نقدية (الجزء الأول)
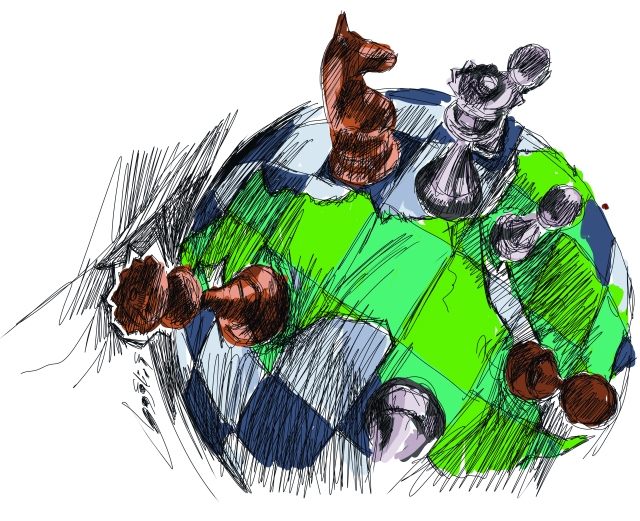

د. مسعد عربيد
مقدمة
لو كنا نعيش أوضاعاً عادية كبقية شعوب الأرض، لما كان لهذه الكتابة حاجة، ولظل التراث شأناً تاريخياً أو ثقافياً وفكرياً وأكاديمياً، ولبقيت صفحات كثيرة منه مطوية في الذاكرة والماضي الموروث، ولما كان موضوع جدل لم يتوقف منذ عقود.
ولكن الثابت والمؤكد في قراءة المشهد العربي أننا نعيش واقعاً مغايراً تماماً. فأوطاننا تقع في دائرة الاستهداف الذي طال عهده حتى تخطى القرنين ووصل حدَّ استباحتها. لذلك لنا أن نقول أننا نعيش مرحلة الاستهداف الإمبريالي الذي دمّر مقوماتنا المادية والمجتمعية، وبات يزعزع هويتنا القومية والثقافية ويهدد مصيرنا.
لم يتوقف هذا الاستهداف عند الهيمنة على وطننا العربي ونهب ثرواته، ولم يكتف بتقسيم وترسيم حدوده السياسية والجغرافية وزرع الكيان الصهيوني في قلبه إمعاناً في التهام أراضيه وتشريد أهله، بل أضحى هذا الاستهداف “السمة الطبيعية” في حياة شعوبنا وتاريخنا المعاصر، وعاملاً رئيسياً ومحدداً لمسار تاريخنا ومصيرنا.
لذا، فإن ما نعيشه ليس كما تعيشه سائر الشعوب، وما نواجهه لا يشبه التحديات التي تعاركها شعوب العالم الأخرى سواء في الاقتصاد والسياسة، أو في التنمية والتقدم والازدهار. لا حاجة لأن نكون من أنصار نظرية المؤامرة للاقتناع بهذا. وليس هذا الكلام تعبيراً لنرجسية في العقل العربي أو لرغبة في التميّز، بل هو واقع مادي ملموس لا يختلف عليه اثنان، وواهم كل مَنْ لا يراه. ولعل الأسوأ من هذا، أنه لا يبدو في الأفق وفي المدى المنظور من مؤشر على تراجع أو تباطؤ هذا الاستهداف، على الأقل من منظور الإستراتيجية الإمبريالية الغربية.
* * *
قد يبدو هذا الحديث تكراراً مملاً أو مغالاة في توصيف الواقع، غير أن كل ما هو حولنا يؤكده.
ولعل التذكير ببعض البديهيات أصبح ضرورة في زمنٍ يطغى فيه الخطاب الإمبريالي وتسيطر فيه سردياته الانهزامية على حياتنا الثقافية والسياسية.
(1)
لقد أسست القوى الاستعمارية لإستراتيجية ثقافية – فكرية للتعامل مع الشعوب المستعمَرة. وقد قامت هذه الإستراتيجية على منهجية علمية ومدروسة تسعى إلى تدمير الوعي الشعبي بغية دفعه إلى الاستكانة والقبول بالخنوع والاستسلام للمستعمِر. وقد كثّف فرانز فانون هذا المفهوم حين قال ما مفاده: يؤسس المستعمِر لدى الشعوب المستعمَرة لثقافية دونية، فيتبنى المستعمَر قيم وأفكار المستعمِر ونموذج ثقافته.
لذا كان تدمير وعي الشعوب دوماً – كغيرة من الأدوات التقليدية في السياسة كالدبلوماسية أو الحرب – سلاحاً في أيدي الأعداء والثورة المضادة والقوى التي ترفض التغيير الاجتماعي – الاقتصادي – السياسي والتي ترى مصلحتها في الإبقاء على أوضاع الاستغلال والظلم التي تعيشها الشعوب. ولهذا السبب ذاته، ظلّ تاريخنا وتراثنا جزءً من المعركة النفسية ومعارك الأفكار والثقافة وسلاحاً ضد شعوبنا. أما الهدف فهو واضح ولا يشوبه لبس أو غموض:
■ تشويه وعي الشعوب بقدراتها وكسر إرادتها في المقاومة والصمود وهدم ثقتها بالنصر والتحرير والعيش الكريم؛
■ وصولاً، وهنا يكمن بيت القصيد، إلى الخنوع والاستسلام واحتقار الذات والقبول بالهزيمة، ومن ثَم استدخالها نفسياً وثقافياً، ما يفضي إلى هزيمة الشعوب من داخلها وفي عمق وعيها الشعبي.
(2)
إن الشعوب التي لا تفهم تاريخها وتراثها لا تحترمه، وتلك التي لا تحترمه فإنها لا تحترم نفسها، وتبقى أسيرة الدونية تجاه الآخر والتبعية للغرب الرأسمالي وأجندته، بل تبقى أسيرة الذل والاستكانة حتى في التعامل مع الحلفاء والاصدقاء، وعاجزة عن الوقوف معهم على قدم المساواة والندّية بما يضمن حفظ المصلحة والكرامة والسيادة الوطنية، من جهة، ويفرض احترام هؤلاء لشعوبنا، من جهة أخرى.
(3)
عاملان أساسيان دفعا التراث العربي إلى صدارة التساؤل في الموقف الثقافي والاجتماعي والسياسي في الراهن العربي:
أ) صعود تيارات وقوى الدين السياسي في العقود الأخيرة ووصولها إلى السلطة في عدد من الدول العربية والإقليمية؛
ب) توظيف هذه القوى والأنظمة – والقوى المحلية والإقليمة والدولية التابعة لهيمنة الرأسمالية والإمبريالية الغربية – للتراث في خدمة أغراضها السياسية والاجتماعية والأيديولوجية، وفي معارك الاستهداف والاستباحة للوطن العربي.
(4)
ليس للصراعات الجذرية في مجتمعاتنا أساساً دينياً أو تراثياً كما تدّعي التيارات الدينية الأصولية والسلفية والتكفيرية. غير أن هذا لا ينفي حقيقة أن الأنظمة والطبقات الحاكمة وقوى الدين السياسي وغيرها من قوى الثورة المضادة والقوى المهيمنة في المجتمع والاقتصاد والسياسة، توظّف، وطالما وظّفت، الدين والتاريخ والتراث كأدوات في الصراعات الاجتماعية – الطبقية والسياسية والثقافية. ويتجلي هذا بوضوح ساطع في الحالة العربية منذ عقود في تفشي الدين السياسي الإسلامي وتياراته وحركاته وأدوته السياسية والإعلامية وغيرها، وخاصة في المأزق الراهن الذي وصلنا إليه، أو أوصلنا إليه ما أسموه “الربيع العربي”. ولا بدّ هنا من الإقرار بنجاح هذه القوى في توظيف الدين كجزءٍ من التراث والثقافة ضد المجتمع، وذلك في ظل غياب الحزب الثوري الذي كان بالمطلق أحد أسباب نجاح الثورة المضادة في تمرير الربيع العربي ومجرياته وما آل إليه.
لهذا نرى أن إشكاليات التراث في بلادنا ومفاهيمه تتجلى في صراعنا مع هذه التيارات والقوى المحلية والعالمية التي ترعاها وتقف خلفها، فتشتد حدة هذا الصراع وامتداداته إلى المستويات التراثية والتاريخية والفكرية والثقافية.
(5)
هنا ربما يلزمنا التأكيد على طبيعة الصراع في بلادنا، المسألة التي كثيراً ما تضيع في خضم مثل هذا الجدل. فجوهر الصراع الرئيسي في بلادنا، في كافة مستوياته الاجتماعية والاقتصادية والطبقية، هو صراع من أجل التحرر الوطني والاجتماعي لشعوبنا:
■ اجتماعياً وطبقياً: وهو صراع ضد الاستغلال الطبقي ورأس المال وكافة قوى الاستغلال والاستبداد (الأنظمة الحاكمة والطبقات والقوى والبني المحلية التي تحميها، وتلك الإقليمية والدولية التي أسست هذه الأنظمة بالأصل وتستمر في دعمها للحفاظ على بقائها)، ولهذا فهو نضال ضد الاضطهاد السلطوي الاستبدادي؛
■ ووطنياً: صراع ضد التبعية للهيمنة الرأسمالية – الإمبريالية والصهيونية وقواها المحلية والدولية التي تحتل أوطاننا وتنهب ثرواتنا ومقدراتنا.
(6)
ليس القصد فيما أقدمه في هذه الدراسة الإيحاء بأن الحل أو البديل يكمن في التراث والرجوع إليه. فالتراث ليس بديلاً عن اجتراح مشروع التغيير والثورة، وما يتطلبه هذا المشروع من نظرية ثورية وبرنامج وقيادة وأدوات، من أجل التغيير الجذري والثوري للأوضاع التي تعيشها شعوبنا.
***
نخلص من هذه المقدمة، أن هذه الدراسة تنطلق من منطلقين أساسييْن:
الأول: حقيقة وواقع الاستهداف الذي يتعرض له الوطن العربي كمحددٍ رئيسيٍ لواقعنا ومسارنا ومستقبلنا، وكعملية مديدة ومستمرة ومحتدمة تستنزف قوانا ومقدراتنا منذ أكثر من قرنٍ ونصف. هذا إذا استثينا الحديث عن دور الاستعمار العثماني في التأسيس لضعف الوطن العربي وتسليمه جاهزاً في ضعفه للاستعمار الغربي الرأسمالي.
أما المنطلق الثاني فهو: ضرورة السعي إلى بناء مشروع تنويري على طريق بناء حركة شعبية توعوية تثقيفية تناضل من أجل هدفين رئيسيين وملحين:
أ) خلق وعيٍ شعبي قادر على استنهاض الشارع العربي واستعادة دوره وقدرته على الفعل في تغيير الواقع والنهوض بشعوبنا ومسيرتها نحو التحرير والحرية والتنمية والتقدم.
ب) مقاومة وتعرية التوظيف الرجعي للتراث في خدمة استهداف بلادنا.
يعبّر هذا، بشكل مكثف، عن السؤال المركزي لهذه الدراسة: كيف لنا أن نجلّس الجدل حول تراثنا في سياق الصراع الاجتماعي – الاقتصادي – السياسي في بلادنا؟
في الخلفية:
السياق التاريخي والسياسي
تزدهر التيارات الدينية بمختلف تلوناتها وتنشط حركاتها – تحت اسم الدين – في أزمنة تراجع المجتمعات والبشرية، وفي سياق انحطاط القيم الإنسانية وغياب الاحترام للحياة والكرامة البشرية. ولكنها، تزدهر أيضاً في سياقات توسع الإمبراطوريات وأطماعها وسعيها وراء الربح وتفشي الاستهلاك. وفي هذا الإطار نفهم توظيف الدين لغايات سياسية واستثمار تأثيراته العقلية والنفسية على الجماهير. وقد رأينا عبر التاريخ أمثلة من ذلك خلال عصور تراجع الدولة العربية العباسية، كما شاهدنا عينات متوحشة منه في عصر ما سُمي ب”فتوحات العالم الجديد” حين وقفت المؤسسة الدينية الكاثوليكية (الفاتيكان) مع الأطماع الاستعمارية والاستيطانية في النصف الغربي من الكرة الأرضية وإبادة الملايين من الشعوب الأصلانية في القارتين الأميركيتين.
ولكن ما يهمنا هنا، هو ما رأيناه ولا زلنا، بعد هزيمة حزيران 1967، حين استفحلت التيارات الدينية الإسلامية بكافة تلوناتها، بما فيها الجماعات الإرهابية، في المجتمعات العربية والإسلامية.
فمع صعود النهوض القومي العربي في خمسينيات القرن العشرين وبروز دوره الإقليمي والأممي، خصوصاً دور مصر الناصرية، في دعم نضال الشعوب العربية وشعوب العالم الثالث، ازدادت حملات التشكيك بقدرة الأمة العربية وشعوبها على النهوض والتقدم وامتلاك قرارها بمصيرها، كما تكاثرت دعوات تحقير الذات العربية وبث روح الهزيمة في جماهيرنا واستدخال الخنوع للأجندات الإمبريالية وخدمة مصالحها.
أخذ التيار العربي القومي بالتراجع في أعقاب هزيمة حزيران 1967، ما خلّف بيئة مواتية لصعود تيارت الدين السياسي – الإسلامي وحركاته منذ سبعينيات القرن العشرين. وفي هذا السياق، احتدت إشكاليات النظرة إلى تراثنا والجدل حوله. واخذ الكثير من السياسيين والمثقفين والمفكرين العرب يربطون تاريخ الأمة العربية وانجازاتها الحضارية بمجيء الإسلام، ومرماهم في ذلك طمس المساهمات الحضارية والثقافية العربية والتقليل من قيمة ودور هذه الحضارة في مرحلة ما قبل الإسلام، والتشكيك في مكانتها بين الحضارات العريقة وثقافات الأمم القديمة (كالهند والصين على سبيل المثال). وفي الوقت ذاته، سلّطت التيارات الأصولية والسلفية الأضواء على الجوانب المظلمة والمتخلفة من تاريخنا وتراثنا وروجت لمقولات تدّعي أن هذه الجوانب هي التعبير عن الإسلام الصحيح والخلافة الإسلامية، وعملت على طمس وتشويه الكثير من التجارب والإنجازات السياسية والفكرية التقدمية والثورية. ولم تكن هذه الإدعاءات بهدف المساهمة في تطوير الفقه أو الفكر الإسلامي، بل من أجل توظيف هذه الإدعاءات في خدمة الثورة المضادة والأنظمة الرجعية، في ظل تلاقي مصالح المؤسسة الدينية مع المؤسسة السياسية الحاكمة.
ثم جاءت الطفرة النفطية في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وفي سياق هزيمة حزيران 1967 وهزيمة المشروع العربي القومي العلماني، وكانت (الطفرة النفطية) من أهم العوامل التي ساعدت في صعود تأثيرات الدين السياسي وتفشي حركاته وتياراته، وأفضت إلى هيمنة أموال النفط على الإعلام العربي والاقتصاد وسياسات الأنظمة العربية بما فيها القومية في مصر وسورية على سبيل المثال. وبفضل هذه الهيمنة على امتلاك وسائل الإعلام، اخترقت تيارات الدين السياسي كافة مجالات الرأي العام من إعلام وثقافة وتمكنت من نشر أفكارها واختراق الوعي الشعبي بغية تدميره وتشويهه. (انظر الآلاف من وسائل الإعلام والفضائيات ومراكز الأبحاث وإصدار الفتاوى في كل صغيرة وكبيرة في يوميات حياتنا وشؤونها الخاصة والعامة).
***
في هذا السياق إنطلقت التيارات الفكرية للدين السياسي وحركاته التنظيمية في تعاملها مع شعوبنا ومجتمعاتنا من كونها مجتمعات تقليدية متدينة. وبفضل امتلاك هذه الحركات قاعدة شعبية عريضة تمكنت من ضمان البيئة السكّانية الحاضنة لها ولأفكارها، وحاولت جاهدةً إقناعنا بزعم كاذبٍ وخادع، وهو أنها، هي وحدها، تملك الحقيقة، كل الحقيقة حول الإسلام والتراث والتاريخ.
نسي هؤلاء، أو تناسوا، أنه ليست هناك “حقيقة” واحدة، بل إن الحقيقة – حتى وفق سردياتهم وطروحاتهم وفتاويهم – قد تناسلت مئات وآلاف المرات، وأن لكلٍ من هذه التيارات “حقيقته” التي يتمترس خلفها ويتحارب عليها وفي سبيلها مع التيارات الأخرى، من أجل تبرير أيديولوجيته وأجندته الاجتماعية والسياسية. كما نسوا، أو تناسوا، أن حقائق التاريخ تقول لنا شيئاً مغايراً تماماً: إن التاريخ العربي – الإسلامي لم يخلُ يوماً من الجدل والخلافات (الفلسفية والفقهية والفكرية) حول موقف الدين من أمور الحياة والدنيا والمجتمع والسياسة، أو حول الخنوع للحاكم أو رفض الطاعة له، بل كانت هناك، وعلى الدوام، حركات وتيارات دعت إلى الخروج على ظلم الحاكم واستبداد السلطة.
ما تجدر ملاحظته هنا، هو أن جوهر محاولات تيارات وحركات الدين السياسي، على اختلاف منابعها وتوجهاتها، كان يرتكز دوماً على مسألة تغييب العقل وتقديس النقل وتوظيف النص الديني في الدين والتاريخ والتراث.
وعلى الرغم من أن صعود تيارات الدين الإسلامي بتياراته الفكرية وحركاته السياسية المختلفة، لم تتأتى إلاّ نتيجة تراجع التيار القومي العربي العلماني، (وهو ما يفسر لنا السهولة والسرعة التي نمت بها هذه الظاهرة)، إلاّ لأنه ليس بوسعنا إغفال ما رافقها من تطورات عميقة في الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية للمجتمعات العربية التي جاءت انعكاساً لتفاقم أوضاع الأغلبية السكانية من الطبقات الشعبية العاملة والكادحة والفقيرة، واحتداد الصراع الطبقي، وامتدادات هذه الصراعات إلى فضاء الفكر والثقافة والأيديولوجيا. وهنا نشاهد تعدد اصطفافات المثقفين ومواقفهم من هذه الصراعات، كل وفق موقفه الطبقي – موقفة من الطبقة التي ينتمي إليها ويمثل مصالحها، أو موقفه من الطبقة/السلطة الحاكمة – فانتهينا إلى الحالة الراهنة في صراع الأفكار والتيارات الفكرية والثقافية والنظرة إلى تراثنا: النظرات السلفية والرجعية من جهة، وتلك التقدمية والثورية التي تقف بالتضاد من الأولى، من جهة أخرى.
***
وبعد،
ماذا كان ردنا على هذه الإدّعاءات؟
ماذا فعلت القوى القومية والشيوعية واليسارية والتقدمية والعلمانية العربية إزاء إدعاءات تيارات الدين السياسي الخادعة والكاذبة؟
ليس هنا مكان التفصيل في هذا الرد، بل ما نستطيع أن نقوله أن جهود هذه القوى ومعها المثقفين والمفكرين العرب – باسثناء قلة قدّمت مساهمات جليلة ودفعت ثمنها غالياً – تعثرت في الرد على هذه الإدعاءات لأسباب عديدة منها الأخطاء في الفهم والممارسة، والوهن الفكري والانهيار الحزبي. كما كان ارتهان بعضها لقوى خارجية إقليمية أو دولية، شكّل أحد الأسباب الهامة، سواء كان ارتهاناً للشرق أو الغرب، للمعسكر الاشتراكي أو الرأسمالي.
وحيث كان العديد من هذه القوى فاقداً للذات والأصالة، ومرتهناً للخارج، فقد عجز عن الإنخراط مع الجماهير في نضالاتها، ما أدى في نهاية المطاف إلى عزوف الجماهير عنها والانفضاض من حولها والابتعاد عنها وعن أفكارها. لهذه الأسباب وغيرها، عجزت هذه القوى عن تأصيل أفكارها ومفاهيمها وتوطينها في الوعي الشعبي العربي.
خلاصة القول، إننا، منذ ذلك الأوان، انشغلنا في الرد على هذه المقولات وأصبحنا في موقع الدفاع عن تاريخنا وحضارتنا وتراثنا.
***
سنوزع ما تبقى من هذه الدراسة على أربعة أجزاء:
1) في الجزء الثاني نتناول قراءة لمستويات التراث مع التركيز على التراث الشعبي والديني.ثُم نستعرض أهم المواقف من التراث: تقديس التراث، والعنف في تراثنا، موقف التنكر لتراثنا واعتباره “ماضوياً، وأخيراً التيار الإنتقائي في النظرة إلى تراثنا.
2) أما في الجزء الثالث فسوف نطرح وجهة نظرنا في فهم العنف في تراثنا وكيف ينظر العقل السلفي إلى هذا التراث.
3) نقترح في الجزء الرابع نهجاً لقراءة التراث يقوم على نقد النهج الإنتقائي، من جهة، والإضاءة على الجوانب الثورية والإيجابية لتراثنا، من جهة أخرى.
4) وفي الجزء الخامس والأخير، نقدم مقترحات لمشروع تنويري تثقيفي عربي تناط به مهمات خلق وعي شعبي جديد.
يتبع … الجزء الثاني
الجزء الثالث